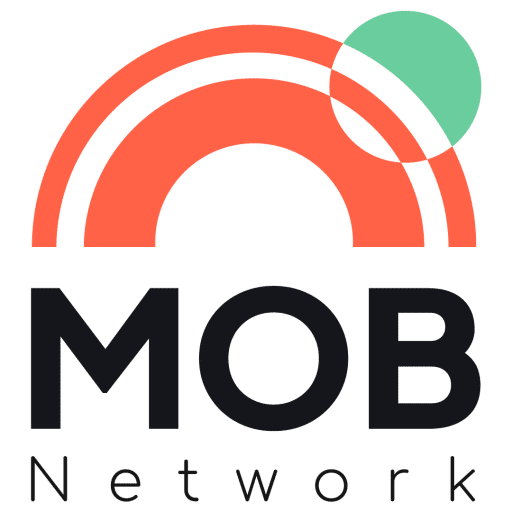لطالما كانت العدالة لا تكتمل إلا بالاستماع إلى المظلوميات ما أمكن، والمصالحة لا تبدأ إلا عندما تُفتح أبواب الحوار على مصراعيها. إذن لابد من أن نتعلم كيف ننصت لبعضنا بعناية، لنكتشف أننا لسنا أعداءً بالضرورة؛ إنما ضحايا رواياتٍ متصارعة، وهنا تكمن الحاجة إلى أدوات فعالة تساهم في كسر دائرة العنف وتعزيز التعايش السلمي. لا تستطيع القوة العسكرية وحدها أن توقف الحروب، ولا الإجراءات السياسية وحدها تعيد السلام إلى المجتمعات الملطخة بالعنف، بل هناك أدوات إنسانية أكثر عمقاً واستدامةً، من بينها سرد القصص وتوثيق التجارب الشخصية.
إن السرد الإنساني هو أكثر من مجرد رواية أحداث، بل هو نوع من المقاومة النفسية والاجتماعية والسياسية التي تمنح مكبر الصوت للفئات المهمشة، كما يمثل أداة مهمة تسهم في بناء جسرٍ من التفاهم والاحترام المتبادل بين الأطراف المتنازعة، وتفتح نافذةً للحوار الإنساني الصادق، كما أن سردَ القصص أداةٌ للمقاومة ضد الطمس والتهميش الذي تتعرض له العديد من الفئات والشرائح في المجتمعات المنقسمة. فعندما يُمنَع الإنسان من التعبير عن مأساته أو معاناته، فإنه يتعرض لفقدانِ جزءٍ مهم من كيانه ووجوده. إن استخدامَ سرد القصص هنا يصبح فعلَ تمكينٍ للفرد، وشهادة على أثر الوجود الإنساني في مواجهة الإقصاء أو القمع.
لقد شهدنا في شتى التجارب التاريخية كيف أن الحديث عن المظلوميات كان وسيلةً للحفاظ على الذاكرة الجماعية، فمثلاً في حالات الاحتلال، أو النزاعات الداخلية، كانت الحكايات الشخصية والمجتمعية هي التي تحافظ على حقائق التاريخ من أن تنطمر أو تتحول إلى رواية الطَرف المنتصر. هذه القصص ليست مجرد حكايات، بل هي مراجعٌ حقيقية وذات وزنٍ دلالي على المعاناة الحقيقية للأفراد وتفضح الآليات التي أدت إلى كافة أنواع الاضطهاد. إن المقاومة بهذه الطريقة تأخذ طابعاً سلمياً، يرفض العنف، ويستخدم الحقيقة والمشاعر الإنسانية كأسلحة للتغيير. فالقصص الشخصية تلقي الضوء على تجارب لم تُروَ من قبل، وتبني قاعدةً واسعةً من التعاطف الجماهيري الذي يمكن أن يشكل نقطة تحولٍ في فهم الأطراف المختلفة للنزاع.
توثيق التّجارب الشّخصيّة: بناء سجلٍّ حيّ يخلق الثّقة
عندما نأتي إلى تدوين هذه القصص وتسجيل الذاكرة الفردية، فإننا لا نتحدث فقط عن جمع المعلومات، بل عن بناء سجل حي يحمل في طياته مشاعر وتجارب حقيقية. هذا التوثيق هو العمود الفقري الذي يقوم عليه أي حوارٍ ناجح ومصالحة محتملة؛ لأنه يجعل الحديث منفتحًا وصادقًا على الوقائع التي حدثت، لا مجرد تصوراتٍ نظرية أو فرضيات.
يشمل التوثيق استخدام مختلف الأدواتِ مثل التَسجيلات الصوتية والمرئية، المذكرات، كتابة الشهادات، أو حتى الرسم والمسرح وغيرها من وسائل التعبير، والتي تعزز من مصداقية القصة وتسمح للآخرين بالاطلاع على البُعد الإنساني وراء النزاعات. وهذه الخطوة تخلق مناخًا أكثر أمانًا للتفاهم، إذ يتعرف كل طرف على وجع الآخر، ويحاول أن يرى الأمور بعين التعاطف. كما يسهم في تقوية الذاكرة الجماعية، فتتوقف المجتمعات عن الانقسام حول ما حدث أو ما يُعتقد أنه حدث، لتصبح هناك مرجعية مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل. هذه السردية تحول النزاع من دائرة الانتقام والإقصاء، إلى نقاش مفتوح يهدف إلى إصلاح مستدام.
سرد القصص كمنصّة تلامس عمق الحوار الإنسانيّ
يتأثر الحوار المجرى في المجتمعات المتضررة بالغضب والشكوك والتراكمات النفسية، الأمر الذي يمنع الأطراف المتناحرة من إيجاد أرضية مشتركة فعلية. هنا يأتي دور سرد القصص كمنصة مختلفة نوعيًا؛ فهو يخلق حوارًا ذاتيًا وإنسانيًا يعتمد على المشاعر والتجارب الخاصة وليس على الحجج أو الانتماءات السياسية أو النزعات الطائفية. فمن خلال الاستماع إلى قصص الآخرين، يبدأ الأطراف في تجاوز الأحكام المسبقة، وتكون قلوبهم وعقولهم أكثر استعدادًا لفهم وجهات النظر المختلفة والانفتاح على الآخر. القصص تذكرهم بشيء عام وشخصي في الوقت نفسه، حيث يشترك الجميع في تجربة الألم والمعاناة، مما يولد نقاط تفاهم عملية للتواصل.
علاوة على ذلك، يتيح سرد القصص فرصًا للتعبير عن الندم، اللوم، الغفران، والأمل؛ فهي مكونات أساسية للمصالحة. عندما تُروى القصص وتُسمع، تصبح بمثابة طقوسٍ جماعية تصهر الأنانية والفردانية في بوتقة جماعية تسلك طريق التعافي. ولكي تؤدي القصص دورها في المصالحة، يجب أن تتحول من خطابٍ أحادي إلى حوار غني متبادل، مما يتطلب:
- الاستماع الجريء: أن نسمع ليس فقط من نتفق معهم، بل من نختلف معهم أيضًا، فالحوار الحقيقي يبدأ عندما نعترف بأن لكل طرفٍ جراحه وحكايته.
- التعاطف عبر السرد: عندما نتعرف على معاناة “الآخر” من خلال قصته، تتحول الأرقام المجردة إلى مشاعر إنسانية مشتركة.
- الاعتراف المتبادل: أن نمنح الشرعية لتجارب الآخرين دون إنكار أو تقليل، فكل قصة تستحق أن تُروى وتُسمَع بإنصاف.
- الانفتاح على التعددية: أن نسمح بتنوع الروايات دون أن نسعى لفرض رواية واحدة مهيمنة، لأن الحقيقة غالبًا ما تكون على شكل فسيفساء مكونة من تقاطع وجهات نظر مختلفة.
- النية في الشفاء لا الإدانة: أن يكون الهدف من السرد هو الفهم والتقارب؛ لا إعادة إنتاج الألم أو تغذية الكراهية.
- الاستمراريّة في الحوار: فالمصالحة لا تحدث في لحظة، بل هي مسار طويل يتطلب صَبرًا وتكرارًا، حيث تُروى القصص مرارًا حتى تُفهم بعمق.
استخدام سرد القصص في مشاريع المصالحة: إرشادات تطبيقية
بعد النزاعات، لابد من تهيئةِ بيئةٍ آمنةٍ لضمان قدرة الأفراد على سرد قصصهم بصراحة وبدون خوف، يجب خلق بيئة آمنة، تحمي المشاركون فيها من الانتقام أو التمييز، سواء من خلال قوانين، دعم مجتمعي، أو سرية المشاركات. كما أنه من المهم تدريب الأشخاص القائمين على الاستماع وسرد القصص على مهارات التفاعل العاطفي، الاستماع النشط، واحتواء الصدمات حتى يستطيعوا توجيه الحوار بشكل بناء، ومن المهم تعزيز روح الشجاعة لدى ذوي المظلوميات للبوح بتجاربهم رغم الألم، مع التوضيح أن الصدق والشفافية في السرد يساهم في تحقيق المصالحة دون تعميق النزاعات. ولا غنى عن إنشاء برامج تعليمية تستخدم هذه القصص لتوعية الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم السلام، الاحترام، والتعايش. وليس عناك خيار آخر سوى خلق منصات مشتركة حيث يمكن للأطراف المتصارعة أن تسمع وتفهم قصص الآخر، مما يساهم في تفكيك الأحكام المسبقة وفتح المجال لحوار صادق. ولا محيد عن المتابعة والدعم المستمرين؛ لأن سرد القصص قد يثير الصدماتٍ و يعيد إضرام الآلام.
حين يقاوم المهمَّشون: السّرد التوثيقيّ كسلاح ضدَّ التّغييب
المقاومة ليست دائماً صاخبةً أو مسلحةً؛ أحياناً، تكون على هيئة حكاية تُروى، وتُسترد فيها الذاتُ من براثن النسيان والقهر. فحين يروي الفرد قصته، فهو لا يمنحها صوتاً فحسب، بل يعيد صياغة وجوده في وجه التهميش. وهذا ما يفعله سرد القصص في سياقات النزاع؛ حيث تتصارع الروايات، وتُمحَى أصوات الضحايا من سجل التاريخ؛ فمن خلال التوثيق الشخصي، يعيد الأفراد كتابة واقعهم بأقلامهم، لا بأقلام السلطة أو القوى المسيطرة، فمقاومة الإقصاء تبدأ حين يُسمَح للضحايا بأن يرووا تجاربهم دون رقابة، وحين تُعترف بمشاعرهم وخسائرهم دون اختزالٍ و تبسيط. في هذه الحالة، يصبح السرد فعلاً سياسياً وإنسانياً، يدافع عن حق الذاكرة وشرعية الألم.
المجتمعات المهمشة غالبًا ما تُقصى من السرديات الرسمية، ويُختزل وجودها في صور نمطية أو يُمحى تمامًا. هنا يأتي السرد التوثيقي ليعيد تشكيل الذاكرة الجمعية، ويمنح الأفراد حقهم في رواية قصصهم من منظورهم الخاص، بعيدًا عن التحيز أو التزييف. وحين يكتبون عن تجاربهم، فهم لا يوثقون الألم فقط، بل يواجهون بنية القمع ذاتها. السرد هنا يتحول إلى سلاح رمزي، يُعيد تشكيل الواقع، ويكشف التناقضات، ويطالب بالعدالة. فهم لا يطلبون الشفقة، بل يطالبون بالاعتراف. والأمثلة وفيرة:
- في فلسطين، يوثق الأدب والشعر والسينما معاناة الشعب تحت وطأة الاحتلال.
- في أمريكا اللاتينية، استخدم السكان الأصليون القصص الشفوية لحفظ تراثهم في وجه الاستعمار الثقافي.
- في سوريا، تحولت يوميات المعتقلين والمنفيين إلى شهادات حية تكشف ما لا تقوله الأخبار.
السرد التوثيقي لا يكتفي بكشف الحقيقة، بل يفتح المجال للحوار، ويؤسس لوعي جمعي قادر على المطالبة بالتغيير. إنه دعوة للتفكر، وفعل مقاومة ضد التغييب، ووسيلة لاستعادة الكرامة، وبوابة نحو العدالة. إنه صوت من لا صوت له، وذاكرة من لا ذاكرة له في كتب التّاريخ الرسمية. وأدواته متنوعة تكاد ألا تحصر مثل:
- الأفلام الوثائقية: تُظهر الواقع بصور حية، وتوصل أصوات من لم يُسمَعوا.
- المدونات واليوميات: توثق التجربة الشخصية وتكسر حاجز الصمت.
- الشهادات الشفوية: تُنقَل من جيل إلى جيل، وتحفظ الذاكرة الجماعية.
في النهاية، يبقى السرد أكثر من مجرد كلماتٍ تُقال أو تُكتب؛ إنه جسرٌ يمتد بين القلوب قبل العقول، يربط بين من عاشوا الألم ومن يسعون لفهمه. حين نمنح أصواتنا فرصةً للخروج من صمت الخوف، وحين نروي حكاياتنا بصدق، فإننا لا نُداوي أنفسنا فقط، بل نفتح نوافذ الأمل في قلوب الآخرين. كل قصة تُروى هي دعوة لأن نرى بعضنا كبشر، لا كأعداء أو أرقام في سجل النسيان. وربما، من بين هذه الكلمات، تولد اللحظة التي نخطو فيها جميعاً نحو مصالحةٍ حقيقيةٍ، أساسها الفهم، واحترام المظلوميات، والإيمان بأن السلام يبدأ من حكاية تُروى بصدق.