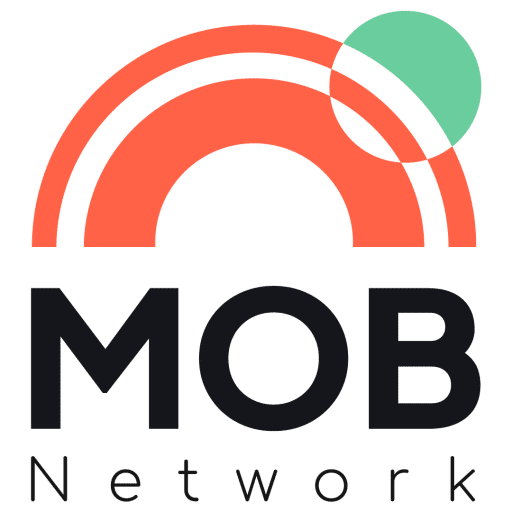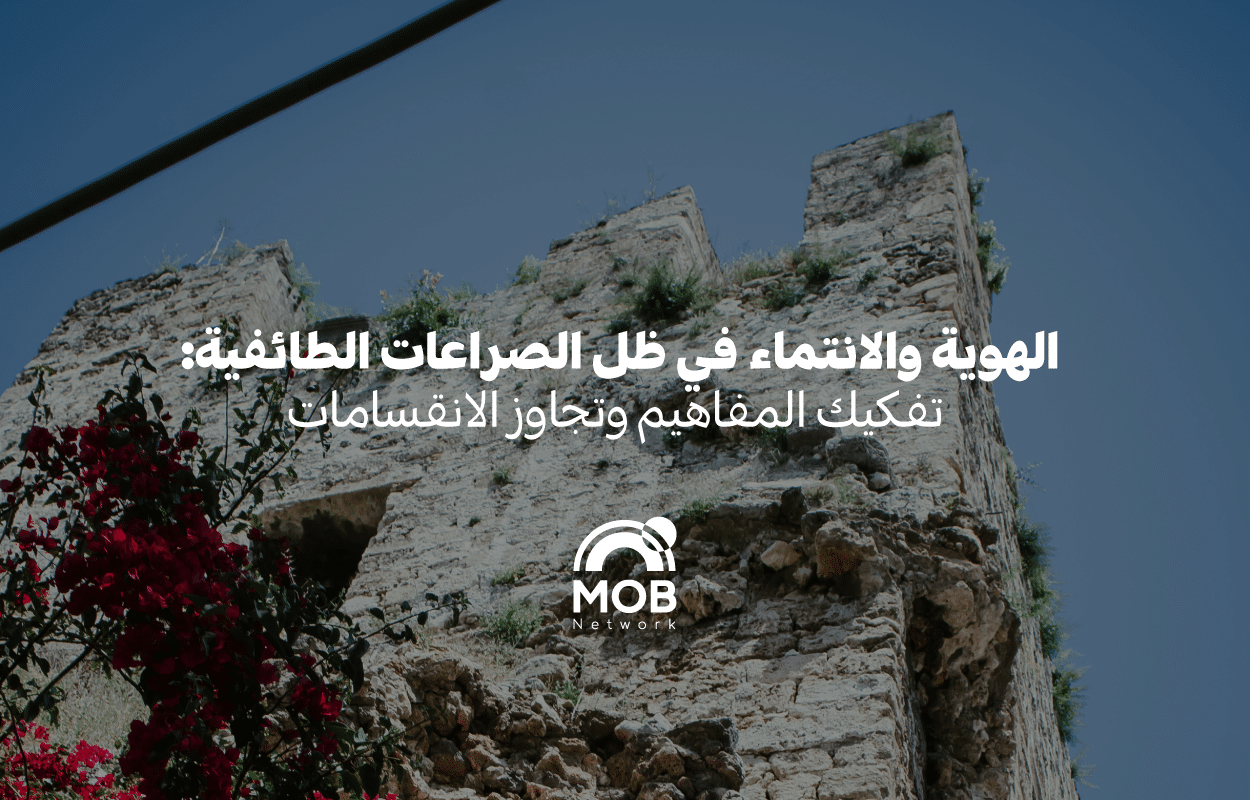يسود اعتقاد خاطئ أن أصل الطائفية في مجتمعاتنا هو غناها بالأعراق والأديان والمذاهب المختلفة، وأن وجود التعدد هذا يشكل نقمةً لا نعمة، وكأن هذه المشكلة نتيجة خلل بنيوي مرتبط بتكوين المجتمعات ذاتها. في الحقيقة، إن هذا التصور ضحلٌ يُغيّب مسؤولية الدولة، التي يجب أن تساوي بين جميع مواطنيها على اختلافهم، وتعاملهم كأعضاء رابطة سياسية واحدة، ضامنة لهم حرية التعبير عن هوياتهم وانتماءاتهم تحت إطار تلك العائلة الوطنية الواحدة.
وهذا مفهوم دولة الأمة التي تؤسس لرابطة جديدة لا تلغي الانتماءات الأهلية، دينية كانت أم إثنية، ولكنها تخلق حيزاً جديداً للتفاعل والتواصل والتعاون وتبادل المصالح، بحيث ينشئ هذا الحيز نفسه عاطفة قرابة ولُحمة جديدة، هو ما نسميه الوطنية. أما ما حدث في أغلب الدول العربية -إن لم يكن جميعها- فهو سلطة استبدادية اتخذت من آليات الإقصاء والاستبعاد منهجاً لها، إذ أنها تقوي وتميز طائفة على حساب أخرى وتقنعها بمصير زوال حتمي إذا رفضت الولاء للسلطة، فهي تدير الأوطان كما لو كانت رأسمالاً خاصاً بها دون وجود حد أدنى من المسؤولية. تتعامل مع الطائفية بوجهين اثنين، فهي من جهة، تصدّع رؤوسنا بشعارات الوحدة والوطنية السطحية وتواري مشكلة الطائفية بقماش، يهب مع الريح في أول عاصفة! ومن جهة فهي تستثمر الكثير لتغذية نفوذها وسلطتها وتعظيم مصالحها.
مفهوما الهوية والانتماء في مرايا الانقسامات

الحديث عن الهوية في زمن الانقسامات الطائفية يشبه المشي على حافة سكين. فالكلمة نفسها تبدو مألوفة، لكنها محمّلة بتاريخ مفعم بالصراع وسوء الفهم، فما الذي تعنيه الهوية أصلًا؟ وكيف يمكن للانتماء، ذلك الشعور الدافئ بالارتباط إلى جماعة، أن يتحول إلى سور عالٍ يفصلنا عن الآخرين؟ وهل الهوية هي حجر ثابت في مكانه، أم أشبه بكائن حيّ يتنفس ويتغير مع تغير الظروف والعلاقات؟.
الهوية والانتماء هما وشاحان منسوجان بخيوط الذاكرة والجذور، نرتديهما دون أن نشعر، ويلازماننا في رحلتنا في الحياة. إنهما أكثر من مجرد مصطلحين، بل هما مرآة تعكس علاقة الإنسان بمحيطه الثقافي، ورابط خفي يشدّه إلى مجتمعه وماضيه، ويهبه شعور الأمان والكينونة. ففي خضم التنوع الإنساني الثريّ، ينبثق مفهوما الهوية والانتماء كأداة لفهم الذات والآخر، فهما يعبّران عن وحدةٍ تُنسَج من اختلاف، وعن تجانسٍ يولد من رحم التعدّد. وعبر الغوص في أعماق هذين المفهومين، نكتشف قدرتنا على مدّ جسور التواصل بين ثقافات شتّى، ونرتقي إلى مستوى من الفهم يتجاوز حدود اللغة والعرق والدين.
إنّ الهوية ليست قيدًا، بل جذورًا نستمد منها معنىً، والانتماء ليس تبعية، بل اختيار يتجلى في التفاعل مع العالم بحسٍّ نابضٍ بالحياة. وبين يدي العولمة والتحولات الاجتماعية، يبقى الوعي بالهوية والانتماء صمّام أمانٍ يحفظ توازن الذات، ويقودها بثبات نحو تواصل أكثر عمقًا وإنسانية.
في المجتمعات التي ابتُلِيَت بالصراعات الطائفية، كثيرًا ما يُعاد تعريف الهوية عبر شعارات حادة، تصنع من الاختلاف خطرًا، ومن الآخر عدوًا، وهذا بحد ذاته إشكال عميق. غالبًا ما يُقال إن الإنسان يحتاج إلى شعور بالانتماء، وهذا صحيح، فلا يوجد أحد يعيش دون جذور! لكن المشكلة تبدأ حين تصبح هذه الجذور مغلقة، لا تسمح إلا بنوع واحد من التربة، ولون واحد من الأوراق، ففي ظل الطائفية، تتحول مفردات مثل “نحن” و”هم” إلى سكاكين لغوية تُقصي بدل أن تُعرّف.
الهوية نهر متدفق لا بئر راكدة
الهوية ليست كيانًا ثابتًا أو صندوقًا مغلقًا نحتفظ فيه بتعريف واحد عن أنفسنا، بل هي نهرٌ متدفق تتغير تضاريسه مع كل منعطف في حياتنا. سارة، المُدرسة السورية التي كانت تعرف نفسها يومًا بأنها عربية، مسلمة، سنية، دمشقية، لم تخن هذه الجذور حين وصفت نفسها بعد سنوات من الاغتراب والدراسة في كندا بأنها كيان يلتقي فيه نهر بردى بنهر سانت لورانس؛ بل كانت ببساطة تعيش عملية التحول الطبيعي لهويتها.
الهوية هي عملية تكوين مستمرة، تتشكل عبر ثلاث طبقات: ثقافية، مهنية، وروحية، كلها تتغير مع الزمن، فالشاب المتحمس لوطنه قد يصبح لاحقًا مؤمنًا بقيم عالمية، والطموح الغامض يتحول إلى هوية مهنية ناضجة، والموروث الديني يتحول إلى إيمان شخصي عميق. هذه التحولات تُصقلها قوى خفية: من الغربة التي تعلمنا أن نعيد تعريف ذواتنا، إلى الأزمات التي تدفعنا لإعادة ترتيب أولوياتنا الروحية والوجودية، وصولًا إلى الفضاء الرقمي الذي يسمح لنا بتجريب هويات متعددة، ومراكمة الانتماءات.
حتى الثوابت الثقافية التي نعتقد بصلابتها، من اللغة إلى التقاليد والقيم، ليست محصنة ضد التغيير؛ فهي تتمازج وتتجدد وتُعاد صياغتها وفق السياقات المعاصرة. وسط كل هذا، لا بد من مقاربة مرنة للهوية: تقبّل التحول لا بوصفه خيانةً للماضي بل كدليل على الحياة، والتمرن على كتابة السيرة الذاتية كل بضع سنوات لاكتشاف ما تغير وما بقي، والبحث عن منطقة التقاء بين الأبعاد المختلفة لهوياتنا، بدل الاكتفاء بإحداها.
هذه التقسيمات التي نشهدها بين مناطق متعددة في سورية هي التجسيد المباشر للأزمة في الهوية الوطنية التي فرغها نظام الأسد من مضمونها. ليحول سورية من ملكية عامة لجميع مواطنيها وشعبها إلى ملكية خاصة بأسرة على طريقة الملوك الإقطاعيين القرسطويين. وليفتت الشعب ويستطيع التعامل معه كطوائف ومناطق وقبائل وعشائر لا كأمة أو رابطة وهوية سياسية موحدة.
برهان غليون Tweet
إعادة تشكيل الهوية لتصبح جامعة لا أداة تفرقة
بناء هوية جامعة يتطلب مشروعاً متعدد المستويات، يركز على الاعتراف بالمظالم التاريخية للفئات المهمشة كخطوة أولى، ويتخذ من العدالة الانتقالية لبنة أساسية لبناء أساس جسر الهوية، والمواطنة التي تحدد الحقوق والواجبات بالانتماء الوطني لا بالهوية الفرعية عماداً لها دون إغفال الإصلاح على المستوى التعليمي عن طريق تعزيز قيم المساواة والهوية الوطنية الجامعة بدلاً من إعادة إنتاج الخطاب الطائفي، فالأجدر بالتعليم أن يظهر التنوع كمصدر قوة لا تهديد.
في حوار أجريناه بأسلوب “مقهى عالمي” في محافظة سورية، طرحنا السؤال الآتي على فئة من الشباب الحيوي المشارك، ما الذي يمكن البناء عليه للوصول لهوية سورية جامعة؟ وكانت الإجابات أقل ما يقال عنها أنها ناضجة وتزهر بالأمل والوعي، ركزت على العمل على إنشاء وتوسيع المساحات الثقافية والتي تجمع الثقافات المتنوعة مما يساهم في معرفة الآخر، وتضمين الهوية الجامعة بشكل مدروس وحقيقي ضمن المناهج السورية ونشر ثقافة الانفتاح وفتح منصات حوار مجتمعية وتنظيم لقاءات تجمع بين مختلف مكونات المجتمع لبناء الثقة وتقليل الأحكام المسبقة. كما ركزت شابة سورية على ضرورة دعم المشاركة السياسية المتساوية وضمان تمثيل عادل لجميع الطوائف في المؤسسات السياسية. ولم يتم إغفال ذكر أهمية تنمية الفنون والثقافة المشتركة من خلال دعم المبادرات الثقافية التي تعكس التنوع وتحتفي به. وبناء مؤسسات مستقلة تعمل على تطبيق القانون بعدالة بعيدًا عن الانتماءات الفرعية.
في إحدى قرى لبنان، يعلق جرس كنيسة فوقه هلال مسجد. هذا المشهد الذي يبدو للوهلة الأولى بسيطاً يختزل جوهر رؤيتنا: الهوية والانتماءات المختلفة ليست سجناً بل بناء نختاره ونشارك في تشكيله والأزمات الطائفية اليوم هي نتاج سياسات قمعية وتهميش متعمد وليست قدراً ثقافياً أو دينياً، والتحرر منها يبدأ عندما نرفض اختزال أنفسنا في هوية واحدة، فليس من المبرر أن نولد في بقعة جغرافية ما، وأن ننشأ ونترعرع تحت تعاليم دين أو مذهب معين، وضمن فئة عرقية محددة ثم نمضي حياتنا في ولاء أعمى دون أن نُعمل عقلنا وننقد بحيادية وأن نتحضر ونترفع عن التعصب وكراهية الآخر.