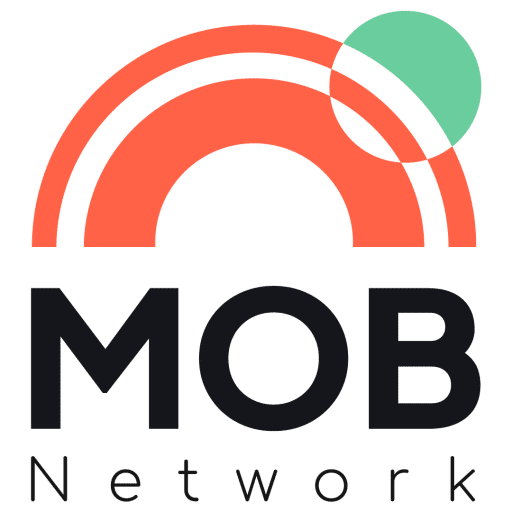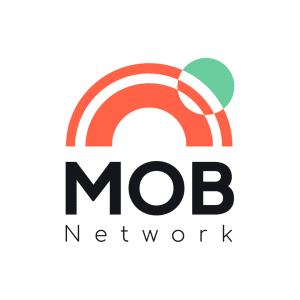يكون وكان، في كل زمان ومكان، أصواتٌ مكتومة، وقلوبٌ مهمومة، وأنفسٌ مظلومة، وروحٌ للحياة والفرح معدومة.
أقنعوها بأنه: “ظِل رجل ولا ظِل حيطة” وأن “الرجل رحمة لو كان فحمة” وما بين بحثها عن الرحمة وحصولها على الفحمة ماتت جسداً و تفحمت روحاً، الكثيرات. وانهدَّت فوق رأسها “حيطان” الظلم والجور والحاجة والأوجاع، وفوقها “حيطان” أحكام المجتمع ونظرته الأقسى، لأنها اختارت طوعاً أو قسراً ظله الظلامي وهي لم تعلم أنها أعلنت عن رحلة ذبولها وأعدت بخيارها نعش موتها البطيء بيديها.
وكثيرات منهن صدقن أسطورة “رجل من خيطان ولا عازة الجيران” فوقعن في شِباكٍ نُسِجَت من ذات الخيطان البراقة وظلت حبيستها إلى أن دُفِنَت فيها، ودُفِنَت معها كل حكاياتِها وأسرارها ودموعها الحارقة للقلب والروح، المهم أنها لم “تَعتَز الجيران”.
ما سَيُحكى الآن ليس بالعادي أبداً _رغم أن الأوجاع التي تتحدّث عنها حكاياتنا القادمة حدثت وتحدث دوماً للأسف_ لكن استثنائية هذا الكلام أتت من أنّ الضحية هي ذاتها صانعة الحدث والبطلة.
لكن وقبل أن نغوص في أعماق القادم من الأحداث وما يرافقها من مشاعر حفرت فيهن وفينا، أريد أن أقف وقفة فخر وامتنان لبطلات حكاياتنا (سارة، نايا، زهرة، ريما…) وأشكرهن على قبولهن بكل محبة إجراء المقابلات ومشاركة تجاربهن بكل شجاعة وكلهن حرصٍ على أن يشاركنَ مفاتيح نجاتهن لكل أنثى لا زالت تعيش مخاض تجربتها حتى ترى النور. بل أريد قبل كل شيء أن أشكرهن على الإلهام الذي قدمنه بصبرهن وإرادة الحياة لديهن، وأنهن صنعن من الموت حياةً وقارباً للنجاة.
تنويه:
- إن أسماء بطلاتنا آنفة الذِّكر اخترناها عوضاً عن الأسماء الحقيقية احتراماً لخصوصية السيدة وتجربتها.
- إن القصص تحتوي على محتوى عنيف، وقد تثير للبعض مواقف أو تستحضر حالات مماثلة في ذاكرتهم، إن ذكرها هو بغرض التوضيح والتوعية والفهم، يرجى مراعاة ألا تُقرأ لمن هم دون السن القانوني.
حكايا الناجيات (1): حكاية سارة /35/ عام:
“الشّاب لا يُفوَّت، وأنت صغيرة لا تعرفين مصلحتك”
تزوجتُ وعمري 16 عاماً، وكان زواجاً قسرياً لأن أسرتي اعتقدت أن لديه كل المقومات التي ترغب بها أية فتاة واقنعوني أيضاً أنني صغيرة لا أعرف مصلحتي. لكن لم أدرِ أنها بداية الكارثة. بعد فترة قصيرة جداً من زواجنا، اختبرت معه كل أنواع العنف، عنف لفظي من شتائم وإهانات، وتقليلٍ من قيمتي، ونكثٍ بكل الوعود والعهود التي وعدني إياها قبيل الزواج، كأن أكمل دراستي أو أن أزور أصدقائي وأعيش حياتي الطبيعية كأي فتاة في هذا العمر. ناهيك عن العنف الجسدي فقد كان يضرب ضرباً مبرحاً جداً ينتهي بالإغماء أو دخولي المستشفى. يتوج هذا الشقاء تدخُّل “بيت الإحما” ليزيدوا قبر موتي اليومي ضيقاً وظلاماً. هل تتخيلون ما معنى أن تتحول الوحشية إلى روتين وأسلوب حياة يومي؟
الطلاق ألف خطٍ أحمر.. ترسمه الأسرة والمجتمع، ومخاوفنا
ظللت أتحمل هذا الظلم لأن الطلاق لدينا وفق موروث العائلة هو “خط أحمر” وممنوع حتى التفكير فيه أو ذكر اسمه، لكن وصلت إلى درجة من الألم النفسي والجسدي لا يُحتمل أبداً، هنا قررت أن أنجو بنفسي من التهلكة بعد خمس سنوات من العذاب وأن أُوقِف نزيف وتهالك روحي وجسدي، وفعلاً نجحت بأن أصل إلى الانفصال النهائي بعد أن لجأت إلى القضاء.
قضيت حينها شهرين قاسيين جداً، كنت أعيش فيهما فقط شعور الخسارة، ليس لخسارتي الشخص بل أني خسرت تجربتي في الزواج، خسرت أيامي وطفولتي، بعدئذٍ عزمت على أن أقف على قدماي وأن أكمل دراستي وأحصل على “البكالوريا”.
أخذت حقي بسلام.. وكلامهم السّلبي كان المحفز
لم أتلق من المجتمع إلا الإحباط. كانت البيئة من حولي تعتقد أنه إذا أكملت تعليمي وصرت أقوى علمياً واجتماعياً فسوف تكثر نقاط قوتي وبالتالي سوف تكثر فرصي العلمية والعملية والعاطفية و”رح بطل أرجعله”. كان علمي يخيف جهلهم وحبي للحياة وبحثي عن منافذ النور يخيف ظلاميتهم. كنت أحول هذا الكلام السّلبي من الناس إلى محفّز بأن أسترد حقي من هذا الكلام عديم الإنسانية والرحمة والاحترام للألم الذي عشته.
وكانت مفاجأة وصدمة الجميع بأني حصلت على مجموع عالٍ في الثانوية ودخلت فرع الجامعة الذي أرغب وأحلم به. وكان اسمي دوماً يتصدر لوائح المتفوقين في الكلية. هنا دخلت في المحطة الثالثة من حكايتي بعد أن أخذت حقي بسلام بنجاحاتي المتتالية دون أن أتعاطى مع المسيئين أو أشغل بالي وأهدر طاقتي بالرد عليهم.
صعوبات جديدة..
لكن استطعت أن أغيّر نظرة المجتمع لي.. عندما غيّرت نظرتي لنفسي
خلال سنوات الجامعة -تكمل سارة- كان شغفي أن أتعلم وأتدرب وأتطور وأن أعوض سنوات كثيرة ضاعت من عمري، حينئذٍ لم يتسنى لي حضور تدريبات مأجورة بسبب ضيق الحال. فاعتمدت على المتاح من التدريبات المجانية ومن المتوفر منها على الإنترنت، واتسعت شبكة علاقاتي ومعارفي وزادت فرصي وخصوصاً التطوعية منها، حيث أن التطوع أعطاني الكثير من الخبرات فكنت أتمكن أكثر وبالتالي تزداد مع تمكّني فرص العمل والتطوع في الجمعيات. شغفي هو ما كان يجعلني أقف دوماً على قدماي وأمضي بخطوات ثابتة، خصوصاً عندما بدأت أحصد نتائج تطويري لذاتي من خلال عدة نجاحات وإنجازات، هنا بدأ تحدٍّ جديد يتعلق بـ “وصمة الطّلاق” وإحباط مضاعف من المجتمع والنظرة المجحفة لها، فكنت ألمح في عيون المجتمع نظرة العار، فهي في مخيلتي فشلٌ يشبه أي فشلٍ آخر كالفشلِ في الدراسة أو التجارة أو أي أمرٍ آخر، لكن بعض الأشخاص الذين يعيشون هذه العقلية أصبحوا يتجاهلونني عمداً ويتجنبون التفاعل معي حتى ضمن العمل الواحد. وأصبحت التعاملات منهم لي في الكثير من الجوانب ترتكز على أني مطلقة وأني “أقل من غيري” وكان لزاماً علي بنظرهم أن أتنازل عن الكثير من الحقوق، كان طعم هذه القسوة تعادل مرارة ما شعرت به من عنف في زواجي، حيث أن من يعنفك ويعتبرك غريمه هو الزوج أما هنا فالمجتمع بمعظمه، وبحكم حاجتك الإنسانية الفطرية فأنت لا تستطيع أن تعيش طوال عمرك من دون “مجتمع” تشعر نحوه بالانتماء. هل تعلمين يا منار ما هو شعور أن تعيشي وأنتِ منبوذة ويجب أن تختبئي وكأنكِ “عاملة عملة”؟!.
مفاتيح نجاتي:
“لا خيار أمامي إلا المضي قدماً للأمام بعد ما حققت الأصعب” هذا ما كنت أردده دوماً مع ذاتي. كانت هي مرحلة تعزيز نقاط القوة ومواجهة نقاط الضعف والمخاوف الداخلية حتى صرت أتحدث عنها بكل شجاعة.
القراءة والمطالعة ساعدتني كثيراً والفيديوهات التحفيزية، وأي فرصة تلوح أمامي كنت استثمرها فوراً ولا أقول “لا” لأي مساحة تطور أدعى إليها. دراستي الجامعية كانت الخط الأحمر. حصلت على الماجستير وأعمل مع العديد من الجمعيات والمنظمات.
مكنت ذاتي بذاتي لأكون أنا طبيبة ذاتي. نظرتي لتجربة الطلاق، آلامي ومخاوفي لم أعد أهرب منها، بل أواجهها بكل احتواء وحكمة، هنا صنعت الفرق الأكبر بيدي، ما بنيته داخلياً خلال عشر سنوات استطعت أن أحققه بسنة واحدة وأن أظهر الحصاد الأهم. أؤمن أنه عندما تكون الأنثى قوية من الداخل فهي قادرة على تحقيق المعجزات، حتى أحكام المجتمع أصبحت أتلقاها كوجهات نظر ولم يعد التفكير بكلامهم يأخذ حيزاً من أفكاري ومشاعري ويمتص طاقتي.
ألخص منهجي في هذه الحكاية: “لا يوجد عندي شيء اسمه نقطة النهاية. كل نقطة نهاية نستطيع جعلها بداية لشيء أفضل ومحطة تحول. إن التمكين، الدعم الذاتي، التدريب، الفرص، التطوع وأن أحيط نفسي بمن يشبهني ويشبه عالمي الداخلي هي مفاتيح نجاة وحياة.”
أسعى لتحويل كل الرسائل السلبية لفرص للتطور وإنجاز شيء جديد. أعلم طريقي وأين أمضي فلا تهمني عثرات الطريق إلا في حال أنها تضيف شيئاً لرحلة تعلمي. أضع كل عام أهداف جديدة وأعمل عليها. أهدافي للعام الجديد الحصول على درجة الدكتوراه بدرجة “امتياز”. وإقامة مشروع ربحي خدمي يؤمن لي الاكتفاء الاقتصادي.
حكايا الناجيات (2): وأما عن نايا ذات التسعة والعشرون ربيعاً فتختصر لنا تجربتها بالتالي:
كنا نلتقي عند شجرة الخرنوب العتيقة الجميلة بعد انتهائنا من الدوام المدرسي، حيث حفرنا عليها حروف أسمائنا ووعوداً كثيرة بالحب والوفاء والإخلاص، كان يفتخر على الملأ أنه حصل على قلب “أجمل فتاة في المدرسة” كما كان يسميني.
هو لم يكمل دراسته بحجة أن العلم “لا يُطعِم خبزاً” وأن تعلم مهنة ما في هذه البلاد هو الأضمن بعد “صف التاسع”.
أما أنا فقد التحقت بفرع الصيدلة وكان الحب ذاته دافعي لأكون الأفضل بين أقراني. أخبرني أن “السيرفيس” الذي يعمل عليه سيكون سفينة “التايتانيك” المتنقلة لعائلتنا المستقبلية ونسج لي الكثير من الحكايا الوردية. تمت الخطبة قبيل التخرج أما الزواج وتدشين “صيدليتي” فكانت خلال الأشهر القليلة اللاحقة للتخرج وكل شيء كان يسير على ما يرام حتى بدأ شيء ما يلوح في أفق زواجنا بعد أيام قليلة منه.
من باب الغيرة والحرص -كما أقنعني- كان يطلب مني ألا أتحدث أمام محضر الضيوف وألا أشارك بآرائي في أي موضوع حتى المواضيع الصحية التي كان يستشيرني بها الأهل والأقارب. حتى وصلت لحد الحرج الكبير منهم وشعرت أن لا منطق في هذا السلوك ولا غيرة تبرر أن أحكم على سنوات دراستي وعلمي وحضوري الاجتماعي بالسجن المؤبد. وكانت المرة الأولى التي أتلقى فيها صفعة نفسية وجسدية عندما قررت مشاركته الضيق الذي أمر به واحترامي لمشاعر الغيرة وحرصي أن يمارسها بشكل منطقي وعقلاني يليق بحبنا وزواجنا.
تعنيف دائم و”تكسير للمجاذيف”.. وذنبها: جمالها وتفوقها العلمي
كان ذلك اليوم هو البداية الأوضح لظهور الوجه الآخر المظلم، لشخصيته المليئة بالثغرات النفسية والتعقيدات و”عقد النقص”، حيث أثبتت كل المعطيات اللاحقة أنه يلجأ لأسلوب “تكسير المجاذيف” وتحطيم معنوياتي والحط من شأني وقدراتي لإحساسه بالتفاوت والتباين بيننا، للأسف هكذا كان يراه في الوقت الذي كنت أرانا ذاتين متكاملتين. لم يكتفِ فقط بتهميش حضوري الاجتماعي والعلمي. بل أنكر كل ما نسجه من “عباراتِ للغزل بجمالي” واعتبر أن ما كان يتكلمه عني طوال هذه السنين هو “كلام مراهقين” لا يُبنى عليه. وأني أحتاج للكثير من عمليات التجميل كي أبدو جميلة، مثل باقي النساء التي يراهن يومياً أو يركبن معه في “التايتانيك”، لقد حاول كثيراً النيل من ثقتي بنفسي.
أجبرني على الإدمان،
واقتلع مني حلمي.. لأن عملي هو المطبخ وليس “طقّ الحنك”
كنت أراه كل شيء في حياتي، كان يراني نداً ومنافساً له في الحضور الاجتماعي علماً بأنني أحترم عمله وخياراته وتفاصيل عالمه حتى “سيرفيسه” المدلل الذي كان يعامله برفق واحترام أكثر مني. لكن شتان ما بين ما كنت أعيشه وما كان يعتقد. لم تتوقف الحكاية عند إحساسه الساخط بالفوارق. فقد أجبرني بالتهديد ومن ثم الضرب على ترك صيدليتي لأن “المرأة مكانها المطبخ” وليس عملها “طق الحنك مع الزبائن” أما الصيدلية فكان يديرها قريبه بحجة أنني متعبة صحياً كوني حامل، والذي بدوره كان يعطيه “الغلة” اليومية من الربح، ليقوم هو بصرفها على ملذاته وسهراته حتى الفجر مع رفاقه. لم يكتف زوجي بأخذ مالي وجهدي وحصاد سنوات علمي وسهر الليالي، بل بدأ يأخذ منها العقاقير المخدرة والتي لا تُصرَف إلا بموجب وصفة طبية رسمية، وكان في كل مرة يشرب بها حبة، يمسك رأسي ويشد شعري بقوة وبلا رحمة ويجبرني على تناول مثيلتها فأتجرعها عنوةً ودموعي تسبق الماء المنسكب مع الدواء. ولم يكترث لعدد الأجنة التي أجهضت حملاً بعد حمل بسبب سوء حالتي النفسية والجسدية وآثار السموم التي أتناولها قسراً، ناهيك عن أن علاقتنا الجسدية كانت قسرية بل كانت اغتصاباً.
هنا أريد أن أنوه إلى شيء هام أرغب بمشاركته مع جميع النساء التي مررن بقصص مشابهة، إن تأخري الكبير في أن أتخذ أي إجراء رادع أو أن أخبر محيطي بما يحدث أعطاه الدافع دوماً لأن يزداد قسوة وعنجهية حيث كان يراني خائفة من ردة فعل عائلتي كوني كنت مصرة على هذا الزواج وأني تزوجته بشكل أشبه بالفرض على العائلة. وأخشى الشماتة وتلويث سمعتي الحسنة كصيدلانية بين زملائي ومجتمعي المحلي. لكن هل أبقى راضية وخاضعة لحكم الوأد لي روحاً وحضوراً وعلماً وجسداً ودفني وأنا حية بين جدران منزله وكلماته المهينة وخيباتي منه اليومية؟
كنت الضحيّة.. اليوم أنا من الناجيات الداعمات لقضايا الأسرة:
هنا كانت بداية النهاية لهذه العلاقة السامة، حيث قررت حينها الهروب من المنزل واللجوء لعائلتي التي عاشت الصدمة والحزن لما حل بي طيلة هذه السنوات، وأمنت لي الحماية كي لا يطالني طيشه. ولأن بيئتنا تعتمد في حل الكثير من المشكلات الاجتماعية على وساطة رجال الدين، فقد ذهبت برفقة والدي إلى شيخ المنطقة الذي تكفل بمساعدتنا، وإقامة مجلس يجمع العائلتين للبحث في القضية وتعويض الضرر وكفالة عدم التعرض للأذى، وتم ذلك أيضاً بمساعدة محامٍ وتم تقديم بلاغ ضده و تخييري بين البقاء معه بعد المحاكمة كزوجة بكفالة عدم التعرض للأذى وبين الانفصال، مع تعويض كافة الأضرار حتى أضرار الصيدلية بالحالتين، لكني اخترت الانفصال ليس لأني لا أسامح أو أدعو للانتقام، فالإنسانية والتسامح لا تعني التفريط والتهاون، لكن هذه الأيام حفرت الكثير من الأخاديد في روحي وقلبي وجسدي، سوف أبداً حياتي العملية من جديد كما الولادة. أتمنى له الشفاء من كل عقده النفسية. لم تكن غايتي أن يُسجن أو يُعاقب، بل أن يتوقف الظلم وأن أدعو كل صوت مكتوم حبيس قيود الظلمة إلى أن يخرج ويرى النور والأذن الصاغية.
أكثر ما كنت أتساءل عنه لمثل هذه الحالات: ألا يوجد مصحات ومراكز تأهيل؟ وأماكن تقدم الاستشارة النفسية حتى لا تتفاقم المشكلات دون أن تُوصم على أنك مجنون في حال ارتدت للعيادة النفسية؟ ألا يوجد مساحات آمنة لتلجأ لها المعنفات؟
الآن أنا سعيدة وكلي رضا أنني أحكي لكم قصتي وأنا مرتاحة وأشعر بالثقة والشجاعة، والحمدلله عدت إلى عملي ونشاطي وشغفي، وحالياً أنا شريك مؤسس لمركز يهتم بقضايا الأسرة والدعم النفسي.
حكايا الناجيات (3): أم البنات وآلة التفريخ
أما زهرة “54” عاماً وريما “46” عاماً واللتان جمعهما القدر كصديقتين فتتقاطع حكاياتهن مع الكثير من السيدات من حيث الأوجاع والحرمان. فالأولى كانت تُعنَّف لأنها “أم البنات” حيث كانت تنجب الفتاة تلو الأخرى وكان الضرب من نصيبها بعد كل ولادة لأنها لم تلد له “ذكراً” يحمل اسم العائلة. أما ريما فهي الزوجة الثالثة لكبير العائلة في منطقتهم وقد تزوجها بطريقة أشبه بصفقة البيع والشراء مذ كانت ابنة الـ 15 عاماً، مقابل قطعة من الأرض ومجموعة من الأغنام لوالديها، تزوجها الثالثة بغرض “التفريخ” لأن المساحات والسهول المزروعة لديه لا تكفيها أولاده من الزوجتين السابقتين البالغين 19 ولداً وفتاة، ولأن كثرة الزوجات والأولاد في مفهوم تلك البيئة هو مؤشر للوفرة والرخاء وتعطي صاحبها هيبة ومكانة اجتماعية. لكن عارضاً صحياً أصابها فلم تنجب له سوى فتاة واحدة وتوقفت بعدها عن الإنجاب. فكان يعنفها على الدوام ويعتبرها أنها “وجه نحس” للعائلة وتتشارك في تعنيفها اللفظي “ضرايرها” حيث يرددن على مسامعها أن لعنةً للفقر تلاحقهم بسببها. فما كان على الزوج ليشفي غليله منها إلا أن يحرمها من المصروف الشخصي واللباس والاحتفالات وحضور المناسبات العائلية أو أن تنجب له المزيد من الأطفال.
التقت ريما وزهرة في دورة لمحو الأمية والتي أقامتها إحدى الجمعيات للريف النائي عام 2009 وتلاقت معهما المواجع والتطلعات لتغيير الواقع والنهوض من الألم. بدأت الصديقتان تمسكان بخيوط النور شيئاً فشيئاً. دورة محو الأمية ومن ثم دورة للخياطة تلتها دورة لإعداد الأغذية، لكن المحطة الأهم كانت بالنسبة لهن هي جلسات قانونية تتعلق برفع الوعي حول الحقوق والمسؤوليات.
زهرة وريما اليوم تديران “مشغلاً” صغيراً للخياطة و”بسطة” في سوق الخضار للمجففات والخضار المقطعة والمربيات.
لم يكن اتخاذ قرار الانسلاخ عن هذه البيئة أمراً سهلاً، تركت ريما المنطقة لتستقر في منطقة أخرى بعد أن توفي زوجها وبعد أن بدأت النزاعات حول “الورثة”، تقول ريما: بعد أن غُيبت كثيراً عن الحياة وأهم حقوقي، قررت الرحيل و”تركت الجمل بما حمل”، وأردت الخروج من هذه الدوامة فقط. أما “زهرة” وبناتها فكن مضرب المثل في المنطقة كلها لالتزامهن الأخلاقي وتحصيلهن العلمي كما تصف زهرة. أما عن زوجها فقد لعبت الوساطات العائلية المتأخرة دورها في تقييد هذا العنف بعد ولادة الفتاة الخامسة وتركها للمنزل ثلاثة شهور حتى عادت بعد ضمانات الوسطاء للزوج أما تحويل شكل عنف زوجها لاحقاً إلى حالة من السكون ثم الندم ومراجعة الذات فكان الدور الأكبر والفضل -كما عبرت زهرة- يعود لذاتها، حيث قامت بالعناية بزوجها حين مرضه وإعالة المنزل اقتصادياً من مشاريعها الصغيرة بعد أشهر من التفاوض والمحاولات لتنفيذها.
إن السيدات الأربع اللواتي شاركنَنا اليوم عوالمهن ومواجعهن ومفاتيح نجاتهن لسن الوحيدات ولا الأخيرات في سلسلة العنف غير المنتهية على هذا الكوكب على اختلاف شدة هذا العنف وشكله، وإن كان هذا المقال مخصص لمشاركة تجارب الناجيات منهن فمن الجدير بالذكر أن الإحصائيات العالمية حول العنف ضد المرأة كلها تشير إلى انتشار مدمر ومتسارع وخصوصاً مع أوقات الطوارئ والكوارث والأزمات.
حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2021 ضمن تقريرها إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف أياً كان شكله وشدته. وأن النساء الأصغر سناً من أشد من يتعرضن للمخاطر. إذ يبلغ الرقم عالمياً 736 مليون امرأة وفق الإحصائيات المذكورة.
يقول المدير العام للمنظمة “إن العنف ضد المرأة متوطن في كل بلد وثقافة ويسبب أضراراً لملايين النساء وأسرهن وقد تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19. ولكن على العكس من المرض لا يمكن وقف العنف ضد المرأة باللقاح. بل بجهود متأصلة ومستمرة تبذلها الحكومات والمجتمعات المحلية والأفراد من أجل تغيير المواقف. وتحسين إتاحة الفرص والخدمات أمام النساء والفتيات. وتعزيز العلاقات الصحية القائمة على الاحترام المتبادل”.
إنهاء العنف ضد المرأة هو شأن الجميع

إن إنهاء العنف ضد المرأة هو شأن الجميع. وينبغي أيضاً أن تفي البلدان بالتزاماتها في سبيل التصدي للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله، عن طريق ما يلي:
- السياسات السليمة التي تؤدي إلى تغيير المفاهيم الجنسانية، من السياسات المتعلقة برعاية الأطفال إلى المساواة في الأجور، والقوانين التي تدعم المساواة بين الجنسين.
- استجابة النظام الصحي المُعزَّزة التي تضمن إتاحة الرعاية التي تركز على الناجيات وإحالتهن إلى الخدمات الأخرى حسب الحاجة.
- التدخلات المدرسية والتعليمية الرامية إلى التصدي للمواقف والمعتقدات التمييزية، بما في ذلك التوعية الجنسية الشاملة.
- والاستثمار الموجه إلى الاستراتيجيات الوقائية المستدامة والفعالة والمسندة بالبينات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
- تعزيز عملية جمع البيانات، والاستثمار في المسوح العالية الجودة للعنف ضد المرأة، وتحسين قياس مختلف أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك النساء الأشد تهميشاً.
نحن نصدق الناجيات
عندما تشارك امرأة قصة تعرُّضِها للعنف، فإنها تكون قد اتخذت الخطوة الأولى لكسر حلقة الإساءة، لذا علينا جميعاً أن نمنحها المساحة الآمنة التي تحتاجها للتحدث بصوت عالٍ، والاستماع إليها.
دعونا نتمهل في إطلاق الأحكام، كأن نقل، “لماذا لم ترحل أو تغادر” أو أن تسمح لنفسك أن تقيم أو تتدخل في رزانتها ولباسها وحياتها الجنسية والاجتماعية.
قل: “نحن نسمعك، نحن نصدقك، نحن ندعمك، نحن نقف معك”.
إن الاستماع للناجيات وفهم القضية والبحث فيها وإعطائهن تلك المساحة الآمنة هي الخطوة الأهم من سلسلة خطواتٍ لضمان أمانها وحصولها على العدالة.
كالفينيق الذي خرج من الرماد، خرجنَ من الظلمة إلى النور، من الموت إلى الحياة، فكن أيها المجتمع عوناً لهن، لا جلاداً عليهن. وكن كفرد منه السدّ الذي تتوقف عنده الشائعات والأحكام وترهات الموروث غير النافع. لنصل إلى مجتمع يؤمن بأنه ليست البطولة والرحمة أن تحصل على زوج “فحمة” لأجل إرضاء المجتمع وكف لسانه بل عندما يلتقيان على فطرة الحب والإنسانية وأن يكونا لباساً وسكناً ومودة ورحمة لبعضهما البعض.