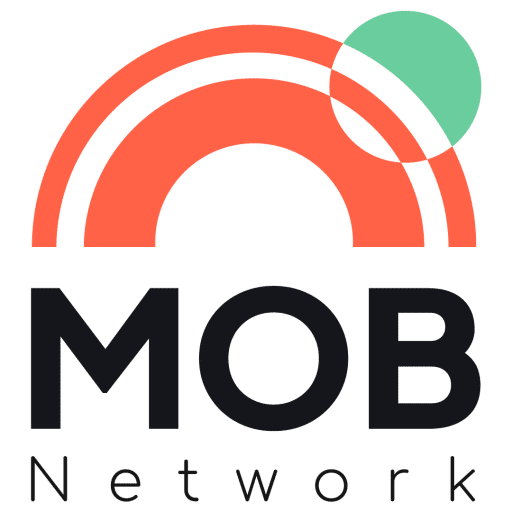في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد وفراره إلى موسكو في ديسمبر 2024، وجدت سوريا نفسها أمام مفترق حاسم، لا تُحدد معالمه الجيوسياسية فقط، بل ترسمه أيضًا المجتمعات المحلية التي طالما وُضعت على الهامش. لأكثر من عقد من الزمن، خاض السوريون حروبًا متعددة الأوجه؛ بين النظام والمعارضة، بين مراكز النفوذ ومناطق التهميش، وبين قوى الخارج ومطالب الداخل. والآن، حين سقط رأس النظام، لم يبقَ في الواجهة إلا من صمد: الناس.
ولطالما تركزت جهود بناء السلام في سوريا حول طاولات المفاوضات الرسمية وتحت مظلة المبادرات الدولية، حيث شُكلت الاتفاقات الكبرى بعيدًا عن واقع الناس، وعادة بمعزل عن الأطراف التي دفعت الثمن الأكبر للنزاع. لكن كل هذه المحاولات أثبتت محدوديتها، بل وفشلها في أحيان كثيرة، حين تجاهلت صوت المجتمعات المحلية التي تعيش النزاع يوميًا، وتدفع أثمانه اقتصاديًا، اجتماعيًا، وإنسانيًا.
فشل السلام “من الأعلى” وصعود دور المجتمعات المحلية
ففي بلدٍ كُسرت فيه الدولة، وانقسمت فيه السلطات، وتمزّق فيه النسيج الاجتماعي، أصبحت المجتمعات المحلية ليست مجرد ضحية للنزاع، بل فاعلًا حاسمًا لا يمكن تجاوزه. المصالحة المجتمعية الحقيقية لا تُفرض من الأعلى، ولا تُهندس من قِبل خبراء دوليين في فنادق العواصم، بل تبدأ من الناس أنفسهم، من الحارات، من العائلات التي تشرذمت، من الأحياء التي تهجّرت. إن التهميش التاريخي لهذه المجتمعات، سواء من النظام قبل الثورة أو من الفاعلين الخارجيين بعد اندلاع الحرب، لم يمنعها من لعب دور مركزي في إعادة بناء الروابط بين الأفراد والجماعات. وها نحن نرى بوضوح أن لجان السلام المحلية، أصبحت مرجعية مجتمعية لإدارة النزاعات، ولمنع التصعيد، ولحماية المدنيين في غياب القانون.
لقد أثبتت التجربة السورية أن بناء السلام لا يمكن أن يكون فعالًا إذا اقتصر على النخب السياسية والدولية. فبحسب دراسة نشرتها جامعة إكستر، إن معظم اتفاقيات السلام التي تمت دون مشاركة المجتمعات المحلية كانت قصيرة الأجل، لأنها لم تعالج الأسباب الجذرية للصراع، مثل الظلم الاقتصادي والتمييز الاجتماعي، وغالبًا ما افتقرت إلى الشرعية اللازمة في نظر المجتمعات المتضررة. بعد سقوط النظام، ظهرت فرصة تاريخية لتمكين المجتمعات المحلية كـمهندسين للسلام، حيث بدأت مبادرات محلية في المناطق التي تحررت من سيطرة النظام أو الجماعات المسلحة تعمل على:
- إنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات بين العائلات والمجموعات المتنازعة، بناءً على الأعراف والتقاليد المحلية.
- إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة عبر جهود تطوعية، تعكس روح التكاتف والاعتماد على الذات.
- تعزيز الحوار بين المكونات المجتمعية المختلفة، بما في ذلك المكونات العرقية والدينية، لترميم النسيج الاجتماعي الممزق.
دور “لجان السلام المحلية” في تعافي سوريا
المجتمعات المحلية تمتلك أدواتها الخاصة لفهم تعقيدات الصراع والسعي لمعالجته، وتملك أيضاً شرعية لا يمكن للجهات النخبوية أو الخارجية أن تحظى بها. هذه الشرعية تنبع من التجربة المشتركة، من الألم المتبادل، ومن الحاجة الملحة لإعادة بناء الحياة. إشراك هذه المجتمعات في جهود المصالحة لا يعني فقط استشارتها، بل تمكينها فعلياً من قيادة المبادرات التي تُعنى بواقعها، سواء عبر لجان الأحياء، أو الجمعيات الأهلية، أو المبادرات الشبابية.
وفقًا لتقرير معهد التغيير السلمي، فإن المبادرات المحلية نجحت في تحقيق مصالحة مجتمعية في مناطق مثل درعا وإدلب، حيث لعبت هذه اللجان دورًا حيويًا في:
- إعادة الثقة: عبر جلسات الحوار المباشر بين الضحايا والجناة، مما يتيح للطرفين سرد قصصهما وفهم الآخر.
- منع الانتقام: من خلال آليات العدالة الانتقالية البسيطة، التي تركز على جبر الضرر وإعادة تأهيل الجناة، بدلًا من العقاب الصارم.
- إعادة الدمج: تسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى قراهم وأحيائهم الأصلية، بما يضمن لهم الأمن والكرامة.
مثال بارز هو لجان الأحياء في دمشق وريفها، التي عملت كوسيط بين الأهالي والسلطات المحلية، وساهمت في حل نزاعات الملكية وإعادة فتح المدارس والمراكز الصحية، مما يعكس قدرة هذه اللجان على معالجة قضايا الحياة اليومية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع. هذه اللجان لم تكن مجرد أدوات تنفيذية، بل كانت مساحات حقيقية للحوار وصناعة القرارات المشتركة.
السلام ليس وثيقة… بل عملية حيّة
السلام، في جوهره، ليس اتفاقاً يُوقَّع بل مسار طويل يتطلّب إشراك كل من تضرر وتورّط وتأثر. وهو يبدأ من الاعتراف بالذاكرة الجمعية للناس، بما تحمله من مآسي، وحنين، ومظالم، ويستمر في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، من فقر وتهميش وغياب عدالة.
المجتمعات المحلية ليست فقط أدرى بتفاصيل حياتها، بل تمتلك كذلك أدوات فريدة لفهم تعقيدات الصراع. هذا الفهم العميق ينبع من التجربة، من معرفة من هو من، ومن تفكيك الشبكات الاجتماعية المعقّدة التي لا تراها المبادرات الدولية ولا تصل إليها تقارير المنظمات. هذه المجتمعات تملك شرعية لا يستطيع المفاوضون حملها، مهما ارتفعت مناصبهم أو دعمتهم العواصم الكبرى. شرعية مستمدة من الأرض، من التاريخ المشترك، ومن الروابط التي نُسجت على مدى عقود، ثم تهشّمت في غفلة من الزمن. هذه الشرعية هي التي تمنح اتفاقيات السلام المحلية وزنها وقبولها بين الناس.
“مبادرون”: تجربة حيّة في إعادة تموضع المجتمعات
في هذا السياق، برزت مؤسسة ” مبادرون” كمثال ملموس على قدرة المجتمعات على التحول من حالة السكون إلى الفعل. فقد عملت هذه المؤسسة على تشكيل لجان محلية في عدد من المناطق السورية، بهدف تفعيل دور السكان في عملية المصالحة. هذه اللجان لم تكن وسطاء محايدين فحسب، بل كانوا نُقاط التقاء بين الجيران، حاملي رسائل سلام، وساعين جادين لإعادة ترميم الثقة في الحي، وتسهيل الحوارات المجتمعية بين مكونات عانت من القطيعة والتشظي.
كما دعمت المؤسسة مبادرات ترميم رمزية، مثل إعادة تأهيل أماكن اللقاءات العامة، أو تنظيم فعاليات تذكّر بالماضي المشترك، دون إنكار الجراح. وهو ما أعاد إحياء ذاكرة مجتمعية كانت آيلة للنسيان، ووضع الناس مجددًا في قلب العملية، لا على هامشها. لقد أظهرت “مبادرون” أن العمل من الأسفل إلى الأعلى هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وراسخ، يُبنى على أسس الثقة والتفاهم المتبادل. هذه اللجان لم تكن فقط وسيطاً بين الأهالي والجهات الرسمية، بل كانت أيضاً محفزاً للعمل الجماعي، وصوتاً حاملاً لمطالب الناس وتطلعاتهم في السلام والاستقرا
السلام الاجتماعي… عمل يومي لا موسمي
الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه معظم مبادرات بناء السلام هو النظر إلى العملية كـ”حدث”، لا كمسار. إذ غالباً ما تُصب الموارد في لحظة محددة، ثم يُترك المجتمع ليكمل الطريق وحده، ما يجعل النتائج عرضة للنكوص. أما السلام الحقيقي، فهو عملية مستمرة، تتطلّب حضوراً دائماً، وقيادة محلية تعرف كيف تستشعر نبض الناس، وتلتقط التغيّرات الدقيقة في المزاج العام، قبل أن تتحوّل إلى انفجار جديد.
من هنا، فإن لجان السلام المحلية ليست خياراً بديلاً عن الحلول السياسية، بل هي القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها تلك الحلول. وإذا لم تكن المجتمعات نفسها جزءاً من السلام، فلن تكون جزءاً من استدامته. إن ديمومة السلام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة المجتمعات على حل نزاعاتها بنفسها، وتكييف آلياتها للتعامل مع التحديات المستجدة.
مهندسو السلام… ليسوا دبلوماسيين بل جيران
من اللافت أن العديد من مهندسي السلام الفعليين لم يدرسوا العلاقات الدولية، ولا يرتدون البدل الرسمية. بل هم شباب الحي، أو معلمة سابقة، أو طبيب ميداني، أو حتى خباز يعرف زبائنه بالاسم. هؤلاء هم الذين يحملون مفاتيح الثقة، ويمتلكون الجرأة للحديث مع الجميع، مهما كانت الانقسامات عميقة. هم الذين يستطيعون الوقوف في وجه الشائعات، ومعالجة الاحتقان، وتهدئة النفوس، لأنهم يعرفون الناس، ويُعرفون بينهم. وإن كان لا بد من تسمية دقيقة، فـ”مهندسو السلام” هؤلاء هم بالفعل العمود الفقري لأي مصالحة حقيقية.
استعادة المجتمعات المحلية لدورها في بناء السلام ليست مجرد فكرة نظرية، بل ضرورة استراتيجية. فالدروس المتراكمة، من سوريا إلى رواندا، ومن العراق إلى كولومبيا، تؤكّد حقيقة واحدة: لا سلام بلا ناس. ولا مصالحة بلا ذاكرة. ولا استقرار بلا عدالة اجتماعية متجذرة في الأرض.
هذا التحوّل من التهميش إلى الفاعلية، هو في حقيقته تحوّل في فهمنا للسلام ذاته. ليس سلاماً فوقياً هشاً، بل سلاماً عضوياً، يومياً، يشتبك مع التفاصيل، ويتغذّى من الثقة المتبادلة، ومن صوت الناس لا صدى السياسيين. إن استدامة السلام في سوريا، أو في أي سياق ما بعد النزاع، تعتمد بشكل كبير على قدرة هذه المجتمعات على استعادة زمام المبادرة، وأن تصبح هي نفسها الحارس الأول والمسؤول عن مستقبلها. فهل نحن مستعدون لمنحهم هذه الفرصة؟